-
℃ 11 تركيا
-
22 ديسمبر 2024
أحمد عزالدين يكتب : تشويه وجوه المحاربين..!
أحمد عزالدين يكتب : تشويه وجوه المحاربين..!
-
13 يونيو 2021, 9:46:00 م
-
 929
929 - تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أرجوكم ألا تقرأوا في هذا المشهد الساقط المُكتئب ، ما يعنى أن شخصاً أدركته شهوة الشهرة ، فأفرغ ما فى جوفه من فضلات على وجوه المشاهدين ، بعد أن دعاه مذيع لا يعرف الفرق بين تنوير الأفكار وتدوير الأموال ، فالمشهد من أوله إلى آخره بأشخاصه ومادته وتوقيته ، وقد حُشر فى قلبه محارب عربى عظيم تم الغدر به ، ليس إلا وجبة مسمومة سابقة الإعداد والتجهيز ، وليس ثمة خيط واحد فى بناء المشهد ومفرداته ، وليد صدفة ، أو خطأ ، فقد دأبت الأفكار المضادة للخصوصية المصرية ، وللتاريخ الوطنى والقومى ورموزه ، وفى مقدمتهم العسكريون والمحاربون ، على أن تأتى فوق أجنحة أمواج كهروماغنطيسية مدفوعة من وراء الحدود .
إن أول ما يستوقفك فى المشهد قبل المادة وقبل الحديث ، أمران متلازمان :
الأمر الأول هو الشخصية المنتقاة أى " صلاح الدين الأيوبى " بثقله التاريخى العسكرى ومكانته فى الذاكرة القومية ، ودائرة حروبه الدفاعية فى مواجهة عواصف جيوش غربية جّرارة ، تدثّرت كذباً بعلم المسيح وهو منها براء ، وذلك فوق خريطة محدّدة تتسع لتشمل مصر وسوريا والعراق وفلسطين واليمن ، وهى البيئة التى تشكل الأعمدة الحضارية التاريخية للعروبة والإسلام معاً .
الأمر الثانى هو التوقيت الزمنى ، فإذا كان " صلاح الدين " هو مجرد رمز غائب لمحارب عظيم ، فإن البيئة هى ذات البيئة ، والعواصف الممتدة هى ذات العواصف ، وهى ماضية فى إستخدام كافة أسلحتها لتحقيق القصد ذاته ، ولذلك فإن المقاربة المصطنعة ليست بين شخص وتاريخ ، وإنما بين تاريخ وتاريخ ، وبيئة وبيئة ، وحدود و حدود ، فإذا كان " صلاح الدين " القائد العسكرى المحارب ، هو أحد الأعلام الأكثر بروزاً وتعبيراً عن فكرة المقاومة شعبياً وعسكرياً فى الوجدان الجمعى العام ، فإن الفكرة فى حد ذاتها هى قلب الهدف قبل الشخص ، فهى مكمن الخطأ ، وربما الخطيئة التى حولت " أحقر شخصية فى التاريخ " – حسب وصف هذا المدّعى – إلى رمز عسكرى تاريخى مشعّ بقيم المقاومة والفداء ، فى سماء التاريخ العربى الإسلامى ، خاصة إذا كان هذا المدّعى قد أتبع حديثه الآثم ، بما أضافه على صفحته من أوصاف لا تقل تدنيّا ودناءه وتحقيراً ، الحقها بمحاربين عظام آخرين ، كان من بينهم ، قائدان عسكريان عربيان ، لكل منهما مكانة خاصة فى التاريخ الحربى العربى ، هما ( قطز ) و ( بيبرس ).
صلاح الدين هنا – إذن – هو مجرد الضوء الثاقب الذى يخطف الأبصار نحو إتجاه معاكس ، ولكنه فى الحقيقة الظل الذى يراد له أن يسلب العيون قدرتها على الإبصار .
ثم أن هناك وشائج أخرى بين البيئة والبيئة ، وعواصف الهجوم الغربى هنا وهناك ، يُراد أن تتمّم عملية " تخليق مشروعيات" جديدة منها ليتم حقن عقول الناس بها ، فإذا كان " صلاح الدين" طائفيّ النزعة على هذا النحو ، كما كان الصدام الذى أحاط به فى دائرة واسعة ، أوسع حتى من حدود مصر ، هو صراع وصدام طائفىّ فى جوهره وفى عمق هذا التاريخ ، أليس من شأن ذلك منح مشروع الحرب الطائفية فى الإقليم والنار تُنفخ فى حطبه على قدم وساق ، مشروعية قديمة معلّقة قبل مئات القرون ، أى أننا لسنا أمام صراع مختلف مستحدث للتغطية على جوهر الإستراتيجية الغربية تجاه الإقليم ، وإنما أمام صراع وصدام طبيعى ، بدليل أن ناره ما تزال متأجّجه فى باطن هذا التاريخ ؟!
وإذا كان " صلاح الدين " عند هذه الدرجة من التوحش وسفك الدماء ، وهدم مكتبات الحضارة ، وقطع النسل عن العباد ، الأ يمكن أن تتخلّق من ذلك مشروعية أخرى ، لسلوك أولئك الذين استعانوا بالصليبيين وملك صقيلية ، على شاكله الوزير ( ضرغام ) الذى عقد صفقة مع الصليبيين ليتولى الوزارة ، بعد احتلالهم لمصر! ، تنسحب بدورها على إختلاق مشروعية جديدة لاولئك الذين إستعانوا بإسرائيل والناتو ، وأدخلوهم إلى غرف عملياتهم العسكرية ، طلباً لمساعدتهم فى مواجهة " حقراء " عرب آخرين ، ما يزالون يقاومون وكأنهم يحاولوا أن يرسموا صورة مصغرة ، لصلاح الدين ؟!.
وإذا كان " صلاح الدين " قد قاوم الفتن والإنقلابات والمؤامرات التى أحاطت به ، وقد كانت خليطاً من بقايا الفاطميين وحلفائهم من أهل السنة ، ومن السودانيين ، بما يتناسب معها من الشدّة والحزم ، خاصة وأن معركتهم لم تكن غير صراع مباشر دام لإسقاطه والإستحواذ على السلطة ، بعد أن سقطت الدولة الفاطمية لعوامل ذاتية بحته ، الا يمكن أن يمتد ذلك إلى تخليق مشروعية موازية ، لإدانة أى مقاومة من جانب سلطة وطنية فى مواجهة فتن وإنقلابات ومؤامرات تحيط بها ، أو يمكن ان تُحاط بها ؟! ، ثم أليس من المدهش إذا أخذنا الأمور بظاهرها ، أن يتم إستدعاء قائد عسكرى محارب ، حرر القدس قبل قرون ، ليتم إلقاء كل هذه اللعنات والبذاءات على رأسه ، بينما الظّن الغالب أن مشروع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، يتأهب للتحرك إلى الأمام ، بعد أيام ، قد لا تطول أسابيع ، وأن يتم – أيضاً – القاء كل هذه اللعنات والبذاءات على رأسه ، ليتم بالتالى تبرئة ساحة أهل الفتنة ، ومنحهم مشروعية السعى للحصول على السلطة بالقوة ، حدّ الإستعانة بجيوش معادية أجنبية ، لمقاتلة وإسقاط أهلهم ومن ينتسبون إليهم باللغة والحضارة والتاريخ والدين ، الا يعد ذلك تذكية ذهنية ، لتمرير بناء تحالف عسكرى تحت أى اسم ، يضم بعض العرب جنباً إلى جنب ، مع خصومهم وأعدائهم ، لقتال أهلهم ، أو من ينتسبون إليهم بالحضارة والدين والتاريخ ؟!.
فى عمق هذا الكلام الضال – إذن – ما هو أبعد من شخص " صلاح الدين " ، وما هو أبعد من تاريخه ، ومن التاريخ الإسلامى الوسيط كله ، فالخطاب ليس مشرعاً من أجل الماضى البعيد ، وإنما من أحل الحاضر ، ومن أجل المستقبل ، وإذا لم نفهم ذلك فهما صحيحاً فلن نرى فيه فى أفضل الأحوال ، الإ إعوجاجاً فى الفكر يستوجب الإصلاح ، أو كسراً فى المنهج قابل للجبر.
ليس عندى بعد ذلك فى معرض الجدل العام والتعليقات التى تلت المشهد ، ما أعتب به على بعض أولئك الذين رفعوا أقلامهم وأصواتهم كالسيوف تأييداً للطعن فى " صلاح الدين " المحارب ، على غرار إحدى عضوات مجلس الشعب ، التى أرسلت تأيدها بسرعة البرق ، فعذرها عندى أنها ما تزال تجلس تحت كرسى الملك فاروق ، لكن العتاب موصول لعدد من الإخوه الأقباط الذين أثق فى وطنيتهم ، فقد أغشى عيون بعضهم حديث الطائفية المنسوب زوراً إلى الرجل ،وربما لو عرفوا أن " صلاح الدين " أختار لمنصب الكاتب الأول لرأس الدولة ، قبطى مصرى هو الشيخ الرئيس صفىَ الدولة ابن أبى المعالى ، وهو منصب يكاد أن يمثل اليد اليمنى لرأس الدولة لكان الموقف مختلفاً ، بل أن ( المقريزى) وهو المؤرخ المنحاز للدولة الفاطمية تماماً ، هو الذى أقر أن فرقاً كاملة من المسيحيين المصريين ، شاركت الأيوبى فى كافة أعماله الحربية ، بما فيها معركة تحرير القدس ، وهو الذى منحهم بسبب ذلك ، دير السلطان ، وسمح لهم بالحج إلى الأراضى المقدسة بعد أن منعهم الصليبيون.
يضاف إلى ذلك أن قبر صلاح الدين فى دمشق لم يتحول من أنقاض حفرة مهدمة إلى ضريح ومقام مكسو بالرخام ، على يد عربى أو مسلم ، فالشخص الذى أقامه وأنفق عليه ، لم يكن مسيحياً فحسب ، ولكنه كان قيصراً ألمانياً هو " فيلهلم الثانى " عرفاناً بالرؤية الأوربية التى ظلت مستقرة فى كتابات المؤرخين والمستشرقين الغربيين ، الذين كانوا يرون الإسلام بعين السخط ، ويرون " صلاح الدين " وحده بعين الرضا.
أما بعض اولئك الذين استحسنوا الطعن فى صلاح الدين ، دفاعاً غريزياً عن الدولة الفاطمية ، فأظن أن الصواب توقيتاً قد جانبهم ، لأنهم إنما يساهمون بذلك فى وضع الأسلحة فى أيدى دعاة الحرب الطائفية فى الإقليم ، إضافة إلى أن " صلاح الدين " لم يأت إلى مصر غازياً ، وإنما جاء مصاحباً "لأسد الدين شركوه" بدعوة من رأس الدولة الفاطمية ، بينما كانت تعانى سكرات الإحتضار البطئ ، بعد أن تحول الطمع فى السلطة إلى مسلسل مفتوح لقتل الخلفاء ، و بعد أن أصبح الوضع الداخلى المصرى مأزوماً حدّ الإختناق ، بينما كانت أطماع الصليبيين لاحتلال مصر ، تتوثّب عبر الحدود ، كما أن صلاح الدين لم يسع إلى منصبه ، وقد عرض الخليفة عليه الوزارة " فتمنع " حتى ألزمه الخليفة " فأُحضروه إلى القصر وخلعت عليه الوزارة ".
إن عندى بعد ذلك ما أرغب فى الإعتراف به ، والإعتراف الأول هو أن " صلاح الدين " واحد من الذين أسروا شعاعاً عميقاً فى وجدانى وعقلى ، حتى أننى أسميت ابنى على اسمه ، وأسباب ذلك ربما ترجع إلى صفته الأساسية ، كمحارب صُلب ، لم يلن ولم يستكن ، وقد قضى فى صحبه جواده وسيفه من عمره ، أكثر مما قضى فى صحبة آله وناسه ، وربما ترجع – أيضاً – إلى فكرة العدل ، التى ظلت فى قلب إيمانه ، فقد ظل شعاره الثابت " العدل مقصد عمرى " ، وربما – أيضاً – لأن " صلاح الدين" لم يأسره من متاع الدنيا شيئاً ، فلم يترك داراً ولا بستاناً ولا عقاراً ، او على حد قول أحد مؤرخيه : " لقد هجر فى محبة الجهاد ، وقنع من الدنيا بالسكون، فى ظل خيمة تهبّ بها الرياح ميمنة وميسرة " ، وعندما مات فى الخامسة والخمسين ، وفتحوا خزانته ، لم يجدوا بها غير دينار واحد ، لم يكن يكفى مؤتة جنازته ودفنه ، حتى أن مستشاره القاضى الفاضل هو الذى تبرع بثمن أثواب دفنه وقبره ، وربما ما أسرنى بالدرجة الأولى فى شخصية الرجل ، انه كان على خلاف كثير ممن سبقوه أو تلوه ، قد تمتع بمفهوم ناضج للعلاقة بين الأمن الداخلى ، والأمن الخارجى ، وعلى جسر هذه العلاقة العميق ، كما امتدت يده لتحصين القاهرة وترميم سورها القديم الذى أحاط بكل أحيائها الفسطاط والعسكر والقطائع ، و أبتنى القلعة ، وعالج كافة الثغور والموانئ بأعمال التطوير والصيانة والتحصين ، امتدت يده فى الوقت نفسه لهدم سجن العامة ، الذى كان معروفاً باسم " دار المعونة " وأنشأ مدرسة أقرب إلى الجامعة مكانه ، قبل أن تتعدد المدارس التى أنشاها ، كما امتدت يده فى الوقت نفسه – أيضاَ – لإنشاء وزارات وداووين أو وزارات لم تعرفها مصر منذ الفتح الإسلامى كديوان الإنشاء ( الإعمار ) وديوان بيت المال ( وزارة المالية ) وديوان الجيش ( وزارة الدفاع ) ، وقد أصبح الأخير ديوان الدواوين أو وزارة الوزارات ، فى ظل ما كانت تواجهه مصر ، والأمة من غزو وأطماع وغزوات أجنبية ومؤامرات محلية .
أما الإعتراف الثانى ، ففيه كثير من الظن وبعض الظن إثم ، فقد اعترانى الشك لحظة فى أن بعضاً ممن يديرون سياسة الإعلام فى بلادنا قد دبّر الأمر بإفتعال قنبلة دخان كبيرة على مقاس صلاح الدين ووزنه العسكرى والتاريخى ، ليغطى دخانها على قضايا أخرى ، تشدّ أعصاب الناس كأنها أوتاراً كمان مشدود ، من الفتنة الطائفية إلى الأسواق المفتوحة للمحتركين والتجار ، إلى عجز الحكومة الذى يتبدّى كأنه ضوء النهار ، لكننى قلت لنفسى أن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحاً ، لأن مردوده عند عموم الناس لن يخرج عن أحد سبيلين ، إما غضب عاصف تحت تأثير إحساس عميق بالإهانة بسبب عاصفة تحاول أن تقتلع من مسلمات الناس ، ما تعلموه فى المدارس ، وما استقر فى يقينهم على أنه أحد البديهيات ، وإما غضب عاصف لإهانة التاريخ ذاته ، وكلا الأمرين لن يكون حميداً ولن يكون حاصل طرح من الأزمات ، وإنما سيكون حاصل جمع إضافى ، لكن ذلك فى كل الأحوال لم يذهب بى بعيداً عما انتهيت اليه ، من أننا أمام عمل مدبّر شكلاً ، وموضوعاً ، مادة وتوقيتاً .
وأننا أمام نار حامية مهمتها إزهاق الذاكرة وملؤها بالشكوك ، وهى نار لن تبرد ، فإذا كان الهدف الإستراتيجى هو تدمير الجيوش ، فإن الهدف الموازى له هو تدمير الذاكرة ، وتشويه وجوه المحاربين ! .

 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 اثنين, 21 يونيو 2021
اثنين, 21 يونيو 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 اثنين, 08 أبريل 2024
اثنين, 08 أبريل 2024 
 أحد, 07 أبريل 2024
أحد, 07 أبريل 2024 
 سبت, 06 أبريل 2024
سبت, 06 أبريل 2024 


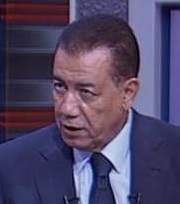

 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب 





