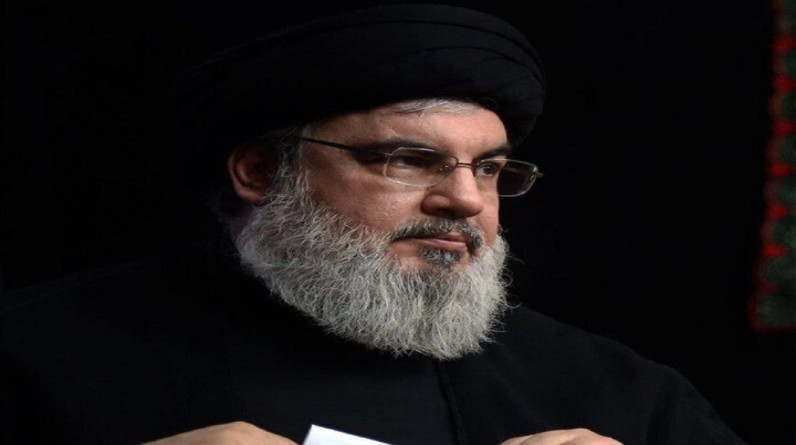-
℃ 11 تركيا
-
2 نوفمبر 2024
اياد ابو شقرا يكتب: موسكو وواشنطن اليوم... غير ما كانتا بالأمس
اياد ابو شقرا يكتب: موسكو وواشنطن اليوم... غير ما كانتا بالأمس
-
6 أغسطس 2023, 5:49:01 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
إن رفع انقلابيي النيجر العلم الروسي، في العاصمة نيامي، مؤشر لا يصحّ التقليل من شأنه، سواء كانت الغاية منه إعلان الولاء أو السعي للاستقواء، ثم أن تشكُّل محوّر عسكريتاري مناوئ لفرنسا، يمتد من النيجر شرقاً إلى مالي وغينيا غرباً مروراً ببوركينا فاسو، يؤكد صحة ما يُرصد من تحوُّلات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى والساحل ضد القوة الاستعمارية المهيمنة سابقاً.
هذا المحوّر المتشكّل يثبت أن ما بدا لبعض الوقت «نزق» شبابٍ عسكري مغامر يتقاطع مع ولاءات قبلية وإثنية وشخصية، بات أكثر من ذلك بكثير، في ظل واقعين:
- الأول، وجود الجماعات المتطرّفة المسلحة - ومنها «داعش» ومشتقاتها - في كيانات المنطقة، وفي طليعتها مالي.
- والثاني، الطموحان المعلنان لكل من موسكو وبكين في «اختراق» مناطق عدة في القارة الأفريقية، اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
في المقابل، لا يجوز أن تُخفي «رمزية» رفع العلم الروسي على وقع التنديد بفرنسا وإرثها ومصالحها المالية والتعدينية في السياق الأفريقي الحالي، حقائق أساسية تتصل بما عاشه العالم طوال معظم فترات القرن الـ20... ولكن بالذات، إبّان «الحرب الباردة» منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحتى انهيار «جدار برلين» و«حلف وارسو» والاتحاد السوفياتي.
طبعاً، يحقّ لانقلابيي النيجر، ولزملائهم في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، الكلام عن «الإرث الإمبريالي» الغربي – والفرنسي تحديداً – لكون هذه البلدان مستعمرات فرنسية سابقاً. وفي الواقع، لم تكتف فرنسا برسم حدود كياناتها، وصنع العديد من نخبها واستغلال مواردها فقط، بل فرضت أيضاً عليها لغتها وثقافتها.
أيضاً، من حق انقلابيي النيجر و«رفاقهم» في بوركينا فاسو ومالي وغينيا - بل كل مواطني البلدان الأربعة - رفض العودة إلى زمان استغلال الحقبة الاستعمارية ثروات المنطقة. وبالمناسبة، فإن اثنين من البلدان الأربعة المذكورة قادهما زعيمان من أبرز زعماء ما كان يُعرف بـ«حركة التحرّر الوطني الأفريقي» التي أنجزت الاستقلال عن الاستعمارين الفرنسي والبريطاني، هما أحمد سيكوتوريه في غينيا، وموديبو كيتا في مالي.
بيد أن الفارق الأساسي في صراع الشرق والغرب على أفريقيا «أيام» سيكوتوريه وكيتا و«يومنا» هذا... هو المضمون الآيديولوجي.
ففي الماضي، كانت «الكتلة الشرقية»، بزعامة الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية، تطرح نظاماً أممياً جديداً يقوم على مفهوم «الاشتراكية العلمية» (أي الشيوعية)، مع القبول بـ«حالات مخفّفة» من الفكر والممارسة «الاشتراكيين» مراعاة لظرف كل بلد وكل زعيم حليف. وكان الخطاب السياسي المعبّر عن هذه «الكتلة» يروّج لطروحاته تحت شعارات العدالة الاجتماعية، ومكافحة آفات الجوع والجهل والمرض، ومحاربة الاستغلال والاحتكارات عبر التأميم، وتأكيد حق الشعوب في تقرير المصير بعيدأً عن مصالح القوى الغربية المهيمنة.
ومقابل هذا النموذج، كان خطاب كتلة القوى الغربية، وبين أقواها قوى «الاستعمار الكلاسيكي القديم»، يسوّق لمصالحها بطرح مفاهيم احترام الحريات العامة، وصون المعتقدات الدينية، والاقتصاد الحر والنجاعة المالية عبر دعم النُّخَب باعتبارها الأقدر «صنع» البحبوحة، والأقدر على إدارة الموارد الوطنية والتفاهم مع الأسواق العالمية.
وهكذا، باختصار، بينما كان الشرق يبشّر بالعدالة والضمانات الاجتماعية (بما فيها التعليم والتطبيب المجانيان)، رأينا الغرب يدافع عن الحرّيات الخاصة، والتديّن، والمبادرة الفردية، وجدارة المُنعَمين بثرائهم ونفوذهم.
لكن هذا الوضع ما عاد قائماً اليوم.
ذلك أن «موسكو - فلاديمير بوتين» ما عادت عاصمة لدولة «اشتراكية سوفياتية» تطرح نظاماً أممياً يعتمد مفهوم «الاشتراكية العلمية»، ولا بكين - شي جينبينغ نسخة ظلت طبق الأصل عن تجربة الرفيق ماو و«مسيرته الكبرى». بل، كما قال لي قريب عزيز وصديق لامع - كان في الماضي شيوعياً ناشطاً - «اليوم فرنسا ودول أوروبا الغربية والشمالية أقرب إلى الاشتراكية من روسيا والصين»!
وبالفعل، الحزب الشيوعي الحاكم سابقاً في روسيا أضحى قوة معارضة هزيلة تقبع في الظل، بينما يدير «الكرملين» ويتحكّم ببلد نظام سلطوي «قومي روسي» و«مسيحي أرثوذكسي» تلعب فيه «الكارتيلات» المالية، و«واجهاتها» من المليارديرات، دوراً مركزياً.
في الصين، أيضاً، لم يبق من «الشيوعية» إلا اسمها؛ إذ تتعايش «الترستات» والمجموعات الصناعية الضخمة - الخاصة والحكومية - جنباً إلى جنب، ويغزو إنتاجها أسواق الدول الرأسمالية، وتُحال أزياء «الرفاق القدامى» من الزي العسكري الخاكي إلى التقاعد... لتحل محلها البدلات الغربية الداكنة وربطات العنق الأنيقة، حتى في مؤتمرات الحزب وزيارات كبار شخصياته إلى الخارج.
ولكن، مهلاً. إذا كانت المفاهيم التي يروّج لها «الشرق» الشيوعي سابقاً قد غدت أثراً بعد عين، ألم يطرأ تطوّر موازٍ على مفاهيم «الغرب» بين الأمس واليوم؟
بلى، باعتقادي طرأ تطور كبير ومقلق على الحياة السياسية في الدول الغربية. وثمة متشائمون يظنون أن التبدلات السياسية - المتطرفة قومياً ودينياً وعرقياً وشعبوياً - التي تعيشها هذه الدول في العقدين الأخيرين أضحت أخطر من أن تلجمها أو تلغيها آليات الديمقراطية الانتخابية، وعلى رأسها تداول الحُكم، واستقلالية السلطات، وحيادية القضاء.
تجارب دونالد ترمب في الولايات المتحدة، وسيلفيو برلوسكوني وورثته من «الفاشيين الجدد» في إيطاليا، وانفصاليي «بريكست» في بريطانيا، ناهيك من تعايش فرنسا مع الحالات «اللوبنية» و«الزمورية» الموغلة في تطرّفها الشعبوية المستفزة لأبشع نوازع العنصرية، كلها تجارب عملية تشي بتناقص «مناعة» الديمقراطيات الغربية ضد فيروس العنصرية الفاشية.
نعم... موسكو وبكين نسيتا اشتراكية الأمس و«طوباوياتها»، ولكن أيضاً ما عاد يحق لواشنطن والعواصم الغربية التبشير بفضائل «سلعها» الديمقراطية التي تُداس يومياً تحت أقدام الشعبويين... وتُهان على منابر إعلامهم.

 سبت, 02 نوفمبر 2024
سبت, 02 نوفمبر 2024 
 سبت, 02 نوفمبر 2024
سبت, 02 نوفمبر 2024 
 سبت, 02 نوفمبر 2024
سبت, 02 نوفمبر 2024 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 جمعة, 28 مايو 2021
جمعة, 28 مايو 2021 
 سبت, 26 أكتوبر 2024
سبت, 26 أكتوبر 2024 .jpg)
 أحد, 06 أكتوبر 2024
أحد, 06 أكتوبر 2024 
 أحد, 08 سبتمبر 2024
أحد, 08 سبتمبر 2024 




 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب