-
℃ 11 تركيا
-
3 أبريل 2025
وسام سعادة يكتب: نقد الحرية هو الشرط الأول لنقد الاستبداد
وسام سعادة يكتب: نقد الحرية هو الشرط الأول لنقد الاستبداد
-
20 مايو 2023, 3:02:32 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
مع أفول ما كان سمّي بكثير من التسرّع «مع أفول ما كان سمّي بكثير من التسرّع «الاستثناء التونسي» دُرِسَت آخر معالم الربيع العربي على مستوى المكتسبات المحققة، لكن الأمر يختلف على مستوى التصدّعات التي أحدثتها الانتفاضات في هياكل الأنظمة. فهذه لم يعالج ولا يمكن أن يعالج أي منها، وهي تستعصي بعد أكثر مع انقطاع الحركة الشعبية، أو تلاشيها. لكنها تولّد بالقدر نفسه الوهم بأن المستعصي معالجته من تصدعات في البنى له ما للاستقرار من رتبة.
لقد تمكنت الأنظمة في كل مكان من العالم العربي من إحباط انتفاضات لم تكن مؤهلة، على ما ظهر، لحمل مشروع ديمقراطي ثوري بالشكل الحاسم، وبما يتجاوز حدود الاقتباس الجزئي والمزاجي والأداتيّ للفكرة الديمقراطية، مهجنة بمعطلّاتها، في معشر الإسلاميين والليبراليين والقوميين واليساريين العرب.
بدل المشروع الديمقراطي الثوري حضرت فوق اللزوم مفردة «الحرية» وعلى نحو يفيد الإرادوية، وتمجيد العفوية معاً. كان للأمر مسوغاته بطبيعة الحال. فأي مصطلح كان بمقدوره أن يندد بالظلم والقهر والاستلاب والاستعباد بشكل أسمى من «الحرية»؟
في الوقت نفسه سمح شعار الحرية بالانضواء تحته للانتفاض معاً في مقابل فهمه بأشكال متناقضة تماماً. إذ يمكنك أن تحيل الحرية كتحرر من الاستبداد على الحرية كتحرر من الشرك. ويمكنك أن تحيلها الى التحرر من الاستعمار، أو الى التحرر من الاستغلال، أو الى الحرية بالمعنى الليبرالي المحددة بحقوق وحريات مقوننة والمنطلقة من تصور متصالح مع أنانية الإنسان، إنما رافض تماماً لأي ربط بهذه الأنانية بالعدوانية. فالإنسان في التصور الليبرالي أناني لأنه غير عدواني. أنانيته من حيث هي فردانية – تملكية تدفعه للتبادل. والتبادل السياسي على صورة التبادل التجاري يكون. وثمة وكالة تجارية، كذلك الوكالة التي ينالها المنتخب من ناخبيه هي على نفس الشاكلة.
والحال أنه، لئن كانت وراء إحباط حركة انعتاق الشعوب العربية أسباب وعناصر كثيرة، فإن تشميع مفهوم الحرية، وعدم مناقشته بشكل جدي، لعب دوراً سلبياً للغاية.
فالحرية بحد ذاتها ليست جواباً كافياً على التحديات التي يفرضها النجاح في إسقاط طاغية، ولا هي الجواب على التعثر في إسقاطه. وهكذا بدت الحرية أشبه ما تكون، بالاستئناف، على نحو موارب، للجدل الكلامي القديم بين الجبر وبين حرية الاختيار والإرادة.
من الزاوية التراثية، بدا موقف المعتزلة المدافع عن كون الإنسان فاعلا حرّا مختارا كما لو أنه معيار تقدير الجذرية الثورية. «الشعب يريد» تغذت من هذه النظرة المعتزلية للإنسان كصانع لأفعاله.
لكن من قال إن الانسان فعلاً «يريد ما يريد»؟ الفكر السياسي للحداثة نهض بالضد من ذلك تماماً في منعرجه الأوروبي. لم ينهض على أرضية تكريس «حرية الإرادة» بل على أرضية نقد تمامية هذه الحرية، والاشتباه بها، إن لم يكن تقويضها.
وهذا انفصال مفصلي في الغرب بين الفلسفة «غير السياسية» وبين تلك السياسية.
لئن كانت وراء إحباط حركة انعتاق الشعوب العربية أسباب وعناصر كثيرة، فإن تشميع مفهوم الحرية، وعدم مناقشته بشكل جدي، لعب دوراً سلبياً للغاية
الفلسفة «غير السياسية» جدّدت مفهوم «حرية الاختيار» إنما بعد أن ألحقته بإختراع جديد: «الأنا». الوعي الذاتي للفرد مرسوماً على أنه اليقين الأوّل. هذا مع ديكارت.
في حين أن الفلسفة السياسية اختارت مساراً مناقضاً. منذ مكيافيللي، مطلع القرن السادس عشر، عندما تطرق الى مسألة الجبر والاختيار. إذ كتب أنه «كي لا يتم إلغاء حرية الاختيار تماماً، أعتقد أن الأقدار تحدد نصف أعمالنا، فيما تتعلق نصف الأعمال الأخرى بنا». فلا يمكنك أن تلغي فيضانات الدهر. إنما عليك بإقامة السدود، وكل سد هو عارض وزائل لا محالة. الفاعل السياسي الحذق هو من يتمكن من انتزاع «المناسبة» في زمان ومكان معينين، بين ما في مستطاعه وبين التحديات التي تواجهه. لكنه ليس هو من يقرر اللحظة، وليس عليه أن ينتظر توفر كل المعطيات كي يُدبر، فالوقت داهم.
بعده بقرن ونصف، كان سبينوزا (ت 1677) يساجل هو الآخر ضد «حرية الإرادة» هذه. الإنسان ليس بأقنوم قائم بذاته. مملكته من مملكة الطبيعة. أن يعتقد البشر بأنهم معتقون من هذه المملكة وضروراتها وشروطها فهذا يجعلهم عبيداً للأوهام والوساوس والجهل، ولبعضهم بعضاً – لا العكس. بدلاً من «الأنا أفكر» الديكارتية، أم كل الفلسفات الذاتية، اكتفى سبينوزا بالعبارة التقريرية: «الإنسان يفكر». مثلها مثل عبارة «الجسم يمتد». وصف لحال، لا يقين أول.
مع مكيافيللي، وبشكل أكثر نسقية مع سبينوزا، نهض تراث فلسفي سياسي غربي كامل ليوجه بجرأة سهامه ضد «حرية الإرادة» التي تجعل الناس يجهدون في سبيل عبوديتهم كما لو كانت معين حريتهم.
فالحرية المكابرة على المحددات تعني الترنح تحت وابل من الأهواء الحزينة. الحرية السعيدة هي على العكس من ذلك. تبدأ بالتفلت من وهم «حرية الإرادة».
لا يلغي ذلك أن إعادة الإعتبار لموضوعة «الديمقراطية» في التاريخ الأوروبي، بعد أكثر من ألفي عام من التحامل عليها على امتداد تاريخ الفلسفة، كان ثمرة التلاقي بين هذا التراث الناقد بعمق لوهم «حرية الإرادة» بالمعنى الكلامي القديم، وبين التراث المستعيد «لحرية الإرادة» إنما في نطاق الوعي الذاتي للأنا الفردية.
الانعطافة هذه كانت مع أعمال جان جاك روسو (ت 1778). حرية الاختيار متأصلة في الإنسان لكنه يفقدها حتماً ما أن ينخرط في المجتمع، عندما تأخذه مغبة مقارنة نفسه بالآخرين يتوقف عن الحرية، يصير عالة على المقارنة. هذا بخلاف تصور روسو للحياة في إسبرطة الإغريقية. ففيها الناس الشجعان من دون فاصل حاد بين حاكم ومحكوم، ولا يضيعون وقتهم في مقارنة أحوال بعضهم البعض. يحبون بعضهم بالانسيابية نفسها التي يعادون فيها أعداءهم. مدهش هنا أساسا كيف أن المفكر الذي لعب الدور الأهم في رد الاعتبار لفكرة الديمقراطية كان معجباً بإسبرطة أكثر من إعجابه بأثينا.
والمفارقة فوق ذلك أن فلسفته في التربية، المفصح عنها في كتابه «إميل» هي على النقيض تماماً من التربية الصارمة المعمول بها في إسبرطة. لكن، بالمحصلة، نموذج إسبرطة استلهمه روسو لأجل إعادة تأسيس المجتمع بشكل يعتق الفرد من دوام مقارنة نفسه بالغير. فهذا هو مناط العقد الاجتماعي. ومع هذا العقد، صار الانتقال من «حرية الإرادة» بمندرجاتها السابقة الى مفهوم «الإرادة العامة». وسيادة هذه كاملة لا يمكن توكيلها الى أي أحد آخر.
ما قرأه البعض تحبيذاً لديمقراطية مباشرة، بدلا من تلك الانتخابية التمثيلية، وقرأه البعض الآخر تمهيدا للتوتاليتارية، فيما تعامل معه خط «الثورة المضادة» لتلك الفرنسية على أنه موضوعة إلحادية بالأساس تنقل صلاحيات «الخلق من عدم» من الإله الى الشعب، ليصار من ثم الى تحكيم مجموعة من القادة الثوريين على الرقاب باسم العقد الاجتماعية والإرادة العامة والسيادة الشعبية التي لا تُسلَب ولا تتجزأ ولا تعطي توكيلاً لأحد.
بالمحصلة، ارتبط انتشال فكرة الديمقراطية في الغرب من غياهب ألفي عام من الإعراض عنها، بهذا التأليف بين نقد حرية الاختيار من جهة في مقال الفلسفة السياسية خصوصاً، وبين إعادة التعرف عليها في نطاق فلسفات الذاتية، بدءاً من «الكوجيتو» (الذات الفردية التي تستمد من وعيها وجودها) عند ديكارت، ووصولاً الى «الواجب» عند كانط (حصر الدلالة العملية للحرية في نطاق القيام بما هو واجب أخلاقياً).
ثم وصل التأليف بين مملكة الضرورة وبين مملكة الحرية الى مفارقته الكبرى مع كارل ماركس. فمن جهة، شدد ماركس على أن «البشر يصنعون تاريخهم لكنهم لا يصنعونه على هواهم» في استمرارية للتراث الناقد لانتفاخة حرية الإرادة. لكنه من جهة أخرى، قد يكون فرّط بهذا الخط، ولو في المجاز، عندما توهّم أنه يمكن أن يؤدي اصطلاح الحال ضمن «مملكة الضرورة» الى شق السبيل «لمملكة الحرية».
وكل هذه المسارات تختلف تمام الاختلاف عن إبقاء فكرة الحرية عربياً في نطاق المنافحة عن «حرية الإرادة» بالمضمون الإعتزالي الكلامي، مهجنة بأدبيات النشاطية المدنية. مع الامتناع عن مساءلة مفهوم الحرية نفسه، ولا السعي للاستفادة من التراث الغربي حوله. وهو تراث لم يتمكن من توسيع مدارك الحرية إلا بنقد «حرية الإرادة» ككل من جانب، وتبديل نطاقها ومنطق اشتغالها من جانب آخر.
كثيراً ما تجد هناك وهناك استعادة لمقولة كارل ماركس الشاب «أن نقد الدين هو الشرط الاولي لكل نقد». ما يغيب عن البال في المقابل أن نقد الحرية كان أساسياً في الفلسفة السياسية الحديثة لانتزاع المزيد من الحرية. واتصل ذلك بالابتعاد أكثر عن الموضوعة الكلامية حول أن «الإنسان مخيّر». الإنسان غير مخيّر في معظم الوقت بالنسبة لأهم محطات الفلسفة السياسية الغربية الحديثة. هو مخيّر في لحظات دون لحظات، وفي أوضاع لا يمتلك بنفسه كل مفاتيحها وشروطها. بالتالي نقد الحرية في أوضاعنا شرط أساسي لنقد الاستبداد. «الشعب يريد» ليست مُلزمة لأن يكون الحاصل على هوى الشعب. أبداً. مقولة «الشعب يريد» تفيد أنه «يريد أن يريد» وليس بأن إرادته هي الصانعة، وحدها، لمآله.
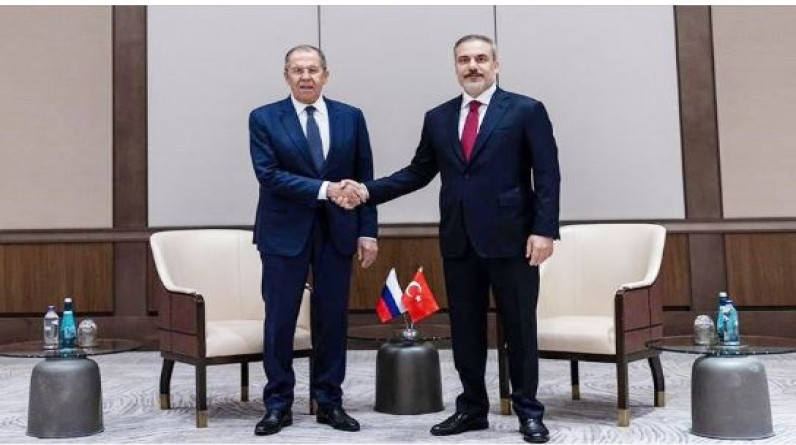
 خميس, 03 أبريل 2025
خميس, 03 أبريل 2025 
 خميس, 03 أبريل 2025
خميس, 03 أبريل 2025 
 خميس, 03 أبريل 2025
خميس, 03 أبريل 2025 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 اثنين, 21 يونيو 2021
اثنين, 21 يونيو 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 أربعاء, 02 أبريل 2025
أربعاء, 02 أبريل 2025 
 أربعاء, 02 أبريل 2025
أربعاء, 02 أبريل 2025 
 أربعاء, 02 أبريل 2025
أربعاء, 02 أبريل 2025 



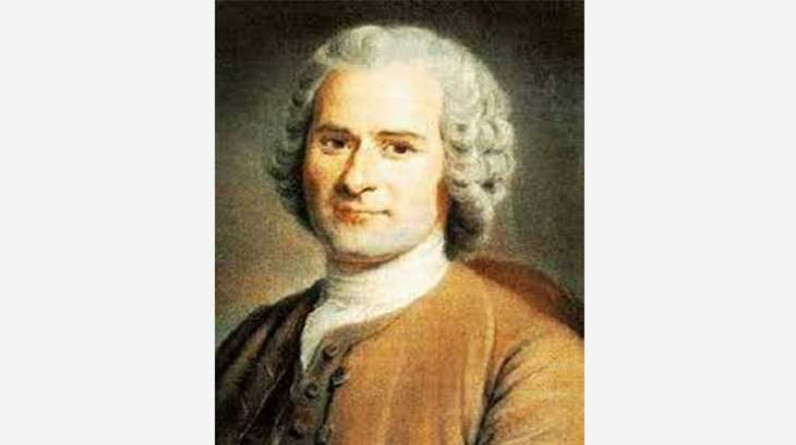
 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب 





