-
℃ 11 تركيا
-
11 يناير 2025
سليمان جودة يكتب: ريان الذي دعانا إلى الحياة وهو يموت!
سليمان جودة يكتب: ريان الذي دعانا إلى الحياة وهو يموت!
-
10 فبراير 2022, 8:11:17 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
كنت في مدينة طنجة قبل سنوات، وسألت عن أقرب منطقة إليها في موقعها الفريد على المتوسط والأطلسي معاً، فسمعت ممن سألته أنني إذا أردت منطقة قريبة أستطيع أن أصل إليها في حدود ساعة من الزمن، فلن أجد أجمل من تطوان ولا شفشاون!
وكنت قد زرت تطوان من قبل، وكنت أسمع عن شفشاون للمرة الأولى، ولكن الذي حدّثني عنها هناك حبّبها إلى نفسي جداً، وأغراني بها لأقصى حد، وقال ما معناه أني سأجد فيها منطقة نادرة، وأن اللون الأزرق السماوي الغالب على مبانيها يميزها عمّا سواها من مناطق المغرب، وأن الذين يزورونها يفتتنون بها، فلا يجدون مفراً من العودة إليها مرة ثانية... وربما مرات!
وقد وجدتها كما قيل لي عنها وأكثر، وبدت لي كأن زرقة المباني فيها تغلّفها بسماء صافية، فكأنك فيها بين سماءين: واحدة تعلوك في غاية الأفق اللانهائي، وأخرى تتمدد أمامك في شفشاون ثم تدور معك في الشوارع، والبنايات، والنوافذ، والجدران، وفي كل ركن من المنطقة تصل إليه قدماك!
ريان مات في لحظة كان أحوج الناس فيها إلى أن يعيش، وكان الناس أحوج ما يكونون فيها إلى أن ينتبهوا إلى ما قصد هو أن يلفت انتباهنا إليه!ريان قصد وروحه تصعد إلى السماء أن يتجسد فيه المعنى الأسمى في هذه الحياة، ولكنه أبى إلا أن يموت بينما هو يدعونا إلى الحياة!
وقد غادرتها في ذلك اليوم، وفي نيتي أن أزورها كلما كنت في المغرب، أو على وجه الدقة كلما كنت في طنجة قريباً منها، ففيها من الأُلفة ما تجده في كل مدينة مغربية تقريباً، وفيها ما يبدو كأنه سر تختص به نفسها ولا تبوح به إلا لزائرها، وفيها ما يظل يشدك نحوها إذا حدث ورأيتها لأول مرة، ولا شيء يمكن أن يقال عنها في مكانها سوى أنها زهرة الشمال في البلاد!
ولأن اسمها يبدو غريباً بالقياس على باقي المدن المتناثرة على خريطة المغرب بموازاة المحيط، فلقد رجعت منها إلى طنجة وأنا أحاول أن أحفظ الاسم بيني وبين نفسي، حتى إذا حدث ووجدت أني بالقرب منها بعدها في أي يوم، ذهبت أمتّع النظر بألوانها الزاهية من جديد!
ولم أكن أعرف وقتها وأنا أردد الاسم في سري، ثم وأنا أجاهد لأعثر له على معنى محدد، أن وقتاً سيأتي عليها كما أتى قبل أيام صارت فيه حديث الدنيا، وربما صارت محسودة على ذلك من كل المدن في أنحاء العالم، وليس في المملكة المغربية وحدها!
وحين جاء هذا الوقت عليها، وحين ارتبط وقتها الذي جاءها بمحنة صغيرها ريان خالد أورام، ثم بموته في آخر لحظات الإنقاذ، فلا بد أنها كانت تصد حسد المدن عنها، ولسان حالها يقول ما كان الشاعر يقوله عن أنه: حتى على الموت لا يخلو من الحسدِ!
ورغم المحن المتكررة التي مر بها أطفال كثيرون في سن ريان، أو في سن قريبة من سنه، وكان أشهرهم محمد الدرة في فلسطين، وإيلان السوري الكردي الذي عثروا عليه مُلقى على وجهه فوق شواطئ اليونان، ومعهما فواز قطيفان المختطف حالياً في إحدى مدن ريف درعا في جنوب سوريا، وغيرهم وغيرهم إلى آخر هذه القائمة التي تعرّي عالمنا المعاصر... رغم طول القائمة فإن ريان كان وسيبقى نسيج وحده بلا مثيل، وكان نادرة سنبقى نذكرها سواء في محنته، أو في موته، أو في طوفان المشاعر التي تدفقت من حوله، أو في صيحات الدعاء التي كانت تشق السماء في مكانه، لعله يخرج من البئر المظلمة التي ابتلعته، وأبت إلا أن تتشبث بجسده الأخضر إلى آخر اللحظات، فلا تلفظه إلا بشق الأنفس، كما كان باطن الحوت قد لفظ جسد يونس عليه السلام!
فليس في العالم صاحب قلب، إلا وقد مال قلبه مع ريان حيث كان يميل ويستقر في قعر البئر العميقة، ولا في الأرض إنسان ذو ضمير حي، إلا وتعاطف ضميره مع ريان حيث كان، ولا على ظهر الكوكب واحد من بني آدم، إلا وقد راحت آدميته تقفز فوق كل الأنباء المذاعة، فتتسمر أمام نبأ ريان على الشاشات التي كانت تنقل خطوات الإنقاذ خطوة من وراء خطوة!
ورغم بُعد المسافة بين المغرب في أقصى غرب عالمنا العربي، وبين الإمارات العربية في أقصى الشرق منه، فإن الحدث الأكبر قد طوى البعد بين البلدين، وجعل الوزير مانع سعيد العتيبة يخرج عن صمته الشعري، فيقول في ريان قصيدة لم يسبق أن قالها في طفل، ويجعل فيها من المعاني ما لا يقوله إلا شاعر مطبوع، كما كانت العرب في قديمها تقول!
وما قاله الوزير الشاعر في قصيدته الباكية، كان أقرب إلى قطرة الماء التي إذا ذقتها أنت أعطتك مذاق البحر كله على طرف لسانك!
وليس سراً أن محنة ريان قد أذابت الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، وجعلت عواطف الكثيرين من الجزائريين تقفز فوق الحدود، فلا تملك إلا أن تشارك كل الناس دعوات القلب التي لم تكن تتوقف، وكان في ذلك ما يكفي لأن يقول إن ما بين الشعوب قد يتوارى قليلاً تحت ضغط الأحداث، ولكنه أبداً لا يغيب ولا يتأخر عن المبادرة بالحضور، إذا ما استعادته المناسبات، وإذا ما أيقظته المحن والملمّات!
تماماً كما جرى على باب معبر «جوج بغال» بين البلدين قبل سنوات، عندما فاز منتخب الجزائر في بطولة أفريقية، فخرج مواطنون مغربيون واحتشدوا بالقرب من باب المعبر، ثم راحوا يلوحون مهنئين للأشقاء في الجزائر على الجهة المقابلة!
كان ريان في قعر البئر يصارع الموت بحثاً عن قليل من الهواء يُبقيه على قيد الحياة، ولكنه لم يكن يدري أنه وهو في غيابة الجب، قد أحيا الآمال من جديد في أرضنا العربية، فنسي الشاعر العتيبة مثلاً أنه إماراتي وأن ريان مغربي، ولم يذكر إلا أنه عربي وإلا أن هذا الطفل عربي في كل حال، وبالإجمال حضر على لسان الشاعر ما يجمع الإنسان مع الإنسان!
ريان تحول من طفل إلى رمز، ومن اسم إلى معنى، ومن صغير بمقاييس السنين إلى كبير بحساب المعاني العالية، ومن معنى إلى مبنى راح يرتفع من المشاعر، والأحاسيس، والعواطف، التي تراكمت من حوله حتى تجسدت في كل شيء نبيل!
ريان الذي عاش لا يغادر شفشاون، ولا يعرفه غير رفاق الطفولة في المكان، مات وهو عنوان للإنسانية في أرجاء الدنيا، ورحل وهو باب من أبواب البراءة التي دخل منها العالم إلى ما أصبح يتغافل عنه من المعاني الجميلة على الأرض!
ريان غادر وقد أصبح اسماً على مسمى في لحظة المغادرة، غادر وهو يعرف أن في اسمه ما يدل على الارتواء بعد العطش الطويل، غادر وقد أرادت السماء أن تجعل من حكايته المملوءة بالأسى، دعوة موحية إلى أن يرتوي منها البشر، وأن يستعيدوا منها أشياء كثيرة صاروا لا يعرفونها في غمرة سباق هذا العصر اللاهث، غادر وقد اجتمعت حوله القلوب كما لم تجتمع حول طفل ولا حول رجل من الرجال!
ريان مات في لحظة كان أحوج الناس فيها إلى أن يعيش، وكان الناس أحوج ما يكونون فيها إلى أن ينتبهوا إلى ما قصد هو أن يلفت انتباهنا إليه!
ريان قصد وروحه تصعد إلى السماء أن يتجسد فيه المعنى الأسمى في هذه الحياة، ولكنه أبى إلا أن يموت بينما هو يدعونا إلى الحياة!
صحافي وكاتب مصري

 سبت, 11 يناير 2025
سبت, 11 يناير 2025 
 سبت, 11 يناير 2025
سبت, 11 يناير 2025 .jpg)
 سبت, 11 يناير 2025
سبت, 11 يناير 2025 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 اثنين, 21 يونيو 2021
اثنين, 21 يونيو 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 اثنين, 25 نوفمبر 2024
اثنين, 25 نوفمبر 2024 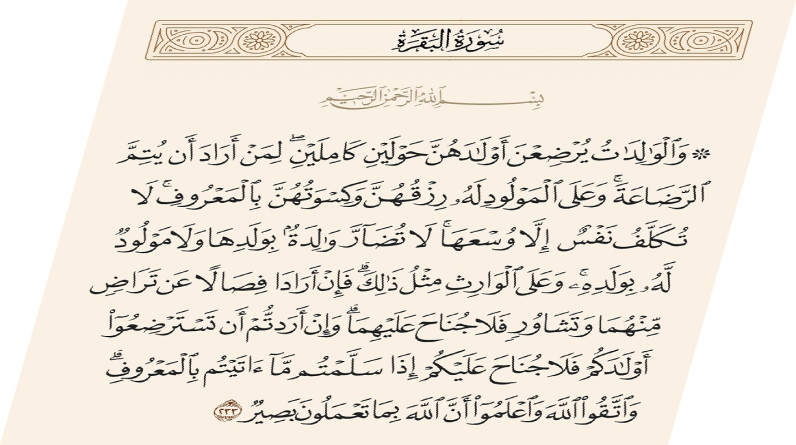
 سبت, 21 سبتمبر 2024
سبت, 21 سبتمبر 2024 




 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب 






