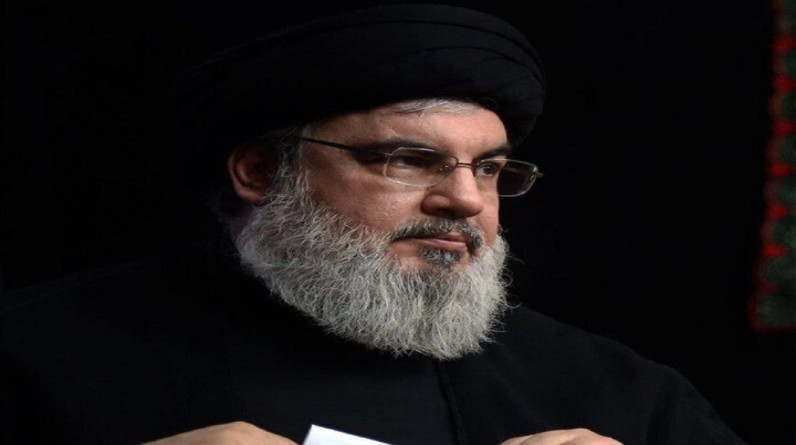-
℃ 11 تركيا
-
2 نوفمبر 2024
عبد الحليم قنديل يكتب: حرب باردة على مسارح ساخنة
عبد الحليم قنديل يكتب: حرب باردة على مسارح ساخنة
-
18 ديسمبر 2021, 9:06:30 ص
-
 474
474 - تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
وكأن التاريخ يعيد نفسه، كاتب روسي اقترح حلا لوقف استفزاز أمريكا لبلاده عبر أوكرانيا، ودعا للتفكير في إقامة قاعدة صواريخ روسية في كوبا، وكأنه يريد استعادة ما جرى أوائل ستينيات القرن العشرين، حين وقف العالم على أطراف أصابعه، وكادت أزمة «خليج الخنازير» تشعل حربا نووية، ووصل التوتر إلى مداه بين أمريكا والاتحاد السوفييتي وقتها، ولم تنزل الأصابع عن الأزرار النووية، إلا بعد التوصل إلى تسوية وتراجع متبادل، ألغت أمريكا بمقتضاه عملية غزو كوبا الشيوعية، وسحبت موسكو صواريخها النووية الاستراتيجية من قاعدتها المتقدمة في كوبا .
وظلت الأزمة الكوبية مثالا كلاسيكيا تجري العودة إليه، وبدواعي التحذير من مخاطر انفلات جامح على القمة الدولية، ونشوب حرب نووية تدمر العالم كله عشرات المرات، خصوصا مع عودة الحرب الباردة الجديدة، ونشوء مسارح ساخنة على خرائطها، وتطور استقطاب دولي جديد، ظلت أمريكا والغرب طرفا فيه، بينما الطرف المقابل يضم روسيا والصين اليوم، وبقدرات تدمير نووية مضاعفة آلاف المرات، قياسا إلى ما كان في قصة كوبا الشهيرة، وعلى مسارح ساخنة لصيقة بالصين وروسيا، من تايوان إلى أوكرانيا، وبدرجات أقل على مسارح أبعد في إيران وإثيوبيا، بينما توارى حضور كوبا، التي ظلت على علاقة جيدة مع روسيا والصين، لكنها لا تملك اليوم ترف المجازفة بالتورط في الصراع الكوني المستجد، وتحرص على مد جسور مع جارتها الأمريكية، قد تساعد في تفريج الكروب الاقتصادية.
ظلت الأزمة الكوبية مثالا كلاسيكيا تجري العودة إليه، وبدواعي التحذير من مخاطر انفلات جامح على القمة الدولية، ونشوب حرب نووية تدمر العالم كله
في أوكرانيا، يبدو المسرح الملتهب، كأنه استعادة لما كان بين موسكو وواشنطن، مع فارق ملموس مرئي، هو أن الخطر اليوم على حدود روسيا لا حدود أمريكا، وقد كانت أوكرانيا من جمهوريات الاتحاد السوفييتي قبل تفككه، وكسبت استقلالها أوائل تسعينيات القرن العشرين، وعلى الخرائط، تبدو أهمية أوكرانيا الحاسمة، فهي أوسع دول أوروبا مساحة بعد روسيا نفسها، وامتدادها غرب روسيا، ومعها على سواحل البحر الأسود وبحر أزوف، لا يجعل موسكو مستعدة لتهاون ولا تسامح، ولا قبول سعي حلف الأطلنطي لضم أوكرانيا إلى عضويته، وتقدم شبكات الصواريخ الأمريكية الأطلنطية إلى حدود روسيا المباشرة، وهو ما يعد خطا أحمر وتهديدا وجوديا، يفسر خشونة التصرفات الروسية العسكرية.
فكما فعلت موسكو مع جورجيا من قبل، وضمت مناطق منها إلى وصايتها، وحالت دون انضمامها إلى «حلف الأطلنطي»، فقد كررت موسكو التصرفات نفسها مع أوكرانيا، وأقدمت على ضم شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول، بضربة واحدة عام 2014، ولم تلق بالا للرفض الأمريكي والأوروبي عالي الصوت، وتحملت سلاسل العقوبات الاقتصادية المتوالية، ثم نقلت المعركة إلى داخل ما تبقى من أوكرانيا، فاللغة الروسية معترف بها في أوكرانيا كلغة رسمية ثانية، ونحو خمس سكان أوكرانيا من أصول روسية، وقد دخلت موسكو طرفا مباشرا في دعم كيانات انفصالية روسية في منطقة «دونباس»، تدير حربا ضد الحكومة الأوكرانية المركزية في كييف، سقط فيها عشرات الآلاف، وتريد هي الأخرى الانضمام إلى روسيا على طريقة القرم، وترعى موسكو مع أطراف أوروبية غربية ما يسمى «اتفاق مينسك»، الذي يهدف لإقامة حكم ذاتي أوسع لجمهوريات الروس داخل أوكرانيا من نوع «دونيتسك» و»لوهانسك»، ولا تكف موسكو عن وضع كييف تحت الضغط، وتحشد على حدودها مئات آلاف الجنود والمعدات، وتجري مناورات في القرم وتجارب لصواريخ «إسكندر» المرعبة، ورغم نفيها نية اجتياح أوكرانيا، إلا أنها لا تتوقف عن تسريب تهديدات باحتلالها، حال ضمها لحلف الأطلنطي، وفي حرب تستغرق أقل من 20 دقيقة، في حين أعلنت واشنطن أنها لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا حال غزوها من روسيا، وهو ما جعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعبر عن فزعه، وعدم ثقته في جدوى تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلم يتغير شيء على الأرض بعد قمة الاتصال المرئي المغلق بين بايدن وبوتين، ولم تؤثر التهديدات بعقوبات اقتصادية قاسية لموسكو في قمم السبع الكبار والاتحاد الأوروبي وقيادة حلف الأطلنطي، وبادرت روسيا إلى فرض سيطرتها المباشرة على سبعين في المئة من «بحر أزوف»، وطردت السفن الأوكرانية، فيما أبدت ألمانيا اعتراضها على تزويد حلف الأطلنطي لأوكرانيا بأسلحة متطورة، وألمانيا هي الطرف الأساسي في عقوبة الحد الأقصى التي تهدد بها واشنطن، أي وقف توريد الغاز الروسي لألمانيا وأوروبا عبر خط «نورد ستريم ـ 2»، وحاجة أوروبا إلى الغاز الروسي، تبدو أقوى من حمية الدفاع عن أوكرانيا، وردع تهديدات روسيا، التي تبدو مستعدة لدفع الصراع إلى الحافة النووية وكسبه بالتخويف.
وفي تايوان، تبدو القصة أعقد، فليس لدى القيادة الصينية أدنى رغبة للقبول بانفصال واستقلال نهائي لدولة تايوان، وهي تصر على استعادتها كجزيرة صينية لحضن البر الصيني، إن سلما أو حربا، بينما تبدو واشنطن حريصة على استقلال حليفتها تايوان، وتواصل استفزاز بكين بالوسائل كافة، بفرض العقوبات الاقتصادية التي لا تجدي مع الصين العملاقة، وبعقد اتفاق «أوكوس» للغواصات النووية مع استراليا، وبتحريك الغواصات النووية الأمريكية إلى بحر الصين الجنوبي، وبخرق اتفاق «صين واحدة»، الذي أبرمته مع بكين أوائل سبعينيات القرن العشرين، وباستضافة تايوان رسميا في قمة المئة الديمقراطية التي عقدها بايدن مؤخرا، لكن بكين ترد بحزم، وتحظر عمليا دخول الغواصات النووية الأمريكية إلى جوارها البحري، وتخوض «حرب ألغام» دمرت بعضها، ومن دون أي إعلان حربي مباشر، وتبعث بقاذفاتها النووية الاستراتيجية إلى سماء «تايوان» كل أسبوع، وتعلن أن غزو تايوان وإخضاعها حال الضرورة، لن يستغرق من قوات الصين سوى نحو سبع دقائق، وأنها لن تستثني من القصف قوات أمريكية إن وجدت على أراضي تايوان، وكلها احتمالات خطر ماحق، خصوصا أن الصين دولة نووية من عقود بعيدة، وتستخدم فوائضها المالية الفلكية في تطوير أسلحتها النووية والصاروخية والفضائية، وبطريقة توحي بأنها قد تصبح القوة العسكرية الأضخم عالميا خلال سنوات، والأعظم امتيازا بصواريخها فائقة السرعة، وبتطورها التكنولوجي المتسارع بشدة، وبخططها لإنشاء نظام مالي عالمي خارج هيمنة الدولار، يلغي مفعول عقوبات واشنطن، وهو ما كان موضعا لبحث جدي في قمة اتصال مرئي قبل أيام، جمعت بوتين مع الرئيس الصيني جين شي بينغ، ناهيك من قوة بكين الاقتصادية والتجارية والمالية، وهي صاحبة أكبر احتياطي نقدي في العالم، يقترب حثيثا من سقف الأربعة تريليونات دولار، وتايوان بالنسبة للصين قضية قومية عظمى لا تفريط فيها، ولا مانع عند بكين من دفع الأمور إلى الحافة النووية من أجل تايوان، بينما لا تبدو واشنطن قادرة على كبح الصين بوسائل الحصار، وبالضغط العسكري التقليدي، ولا المخاطرة بالتورط في «حرب نووية» لا يفوز بها أحد.
وعلى مسرح الحروب بالوكالة والأصالة البعيدة عن حدود روسيا والصين، لا تبدو واشنطن في وضع يؤهلها للهجوم، بعد خروجها المخزي مع الحلفاء الأطلنطيين من أفغانستان، وتعثر دبلوماسية بايدن مع إيران، ومصاعب التوصل إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وعبث التلويح بضرب منشآت إيران النووية تحت الأرض، حتى لو جرى تكليف «إسرائيل» بالمهمة، التي بافتراض إتمامها ونجاحها جزئيا، فلا تبدو كفيلة بنيل المطلوب، فقد راكمت طهران معرفة نووية يعتد بها، وضرب المنشآت لن يعيقها كثيرا، وسبيلها إلى القنبلة النووية سالك، وقد لا تكون روسيا والصين سعيدتان بالقنبلة الإيرانية إذا صنعت، لكن مقتضيات الحرب الباردة الجديدة تفرض اعتباراتها، إضافة لأهمية إيران وجغرافيتها ومواردها في الصراع الكوني المرشح للتفاقم، وقد لا تغامر موسكو ولا بكين بخوض حرب دفاعا عن إيران، ولا بدفع الصدام على القمة إلى حرب نووية من أجل طهران، فإيران ليست أوكرانيا ولا تايوان، بل مجرد مسرح يجري التزاحم والتدافع عليه، تماما كمسرح إثيوبيا التي تعاني من حرب دمار ذاتي شامل، تحاول الصين دعم أحد أطرافها ممثلا في حكومة آبي أحمد، وبدواعي الخشية على استثماراتها الهائلة في أديس أبابا، وقد جرى تدمير وتفكيك ونهب مئات المصانع في الأمهرة والتيغراي، وأغلبها باستثمارات صينية، وبدا للصين أن الحرب حسمت لصالح حليفها، بالتفوق الجوي والطيران المسير، لكن حروب العصابات على الأرض عادت مجددا بعد أيام، وفي جولات كر وفر وسحق بلا رحمة، وقد تنتهي في زمن قريب إلى فناء إثيوبيا وتقسيمها نهائيا، وبلا مبالاة أمريكية غالبا، بقدر ما تفرح واشنطن بخسائر الصين وتآكل نفوذها.
مصدر المقال: القدس العربي

 سبت, 02 نوفمبر 2024
سبت, 02 نوفمبر 2024 
 سبت, 02 نوفمبر 2024
سبت, 02 نوفمبر 2024 
 سبت, 02 نوفمبر 2024
سبت, 02 نوفمبر 2024 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 جمعة, 28 مايو 2021
جمعة, 28 مايو 2021 
 أربعاء, 04 سبتمبر 2024
أربعاء, 04 سبتمبر 2024 
 جمعة, 21 يونيو 2024
جمعة, 21 يونيو 2024 
 خميس, 08 فبراير 2024
خميس, 08 فبراير 2024 




 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب