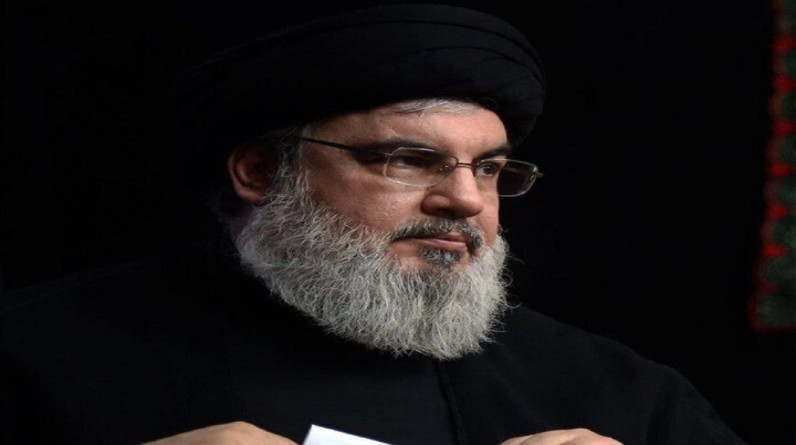-
℃ 11 تركيا
-
2 نوفمبر 2024
هشام جعفر يكتب: المزاحمة بين سياستي الهوية والتوزيع في المنطقة العربية
هشام جعفر يكتب: المزاحمة بين سياستي الهوية والتوزيع في المنطقة العربية
-
23 يوليو 2023, 6:24:18 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أحب أن أبدأ بالعنوان حتى لا أترك القارئ نهبا لهذا العنوان الغامض فأقول أولا إن المقصود بسياسات الهوية في منطقتنا؛ القضايا التي تدور حول علاقة الدين بالمجال العام وخاصة هوية الدولة، إلا أنها صارت تكتسب معنى متسعا في السياسة المعاصرة من خلال الحديث في القومية والمهاجرين والعنصرية واليمين المتطرف، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القضايا والاتجاهات الفكرية الأخرى التي هي من طبيعة ثقافية وليست اقتصادية مثل: ما بعد الحداثة، والتعددية الثقافية، والنسوية، وما بعد الاستعمار.
أما سياسات التوزيع فالمقصود بها التساؤل حول التوزيع العادل للثروة والدخل والفرص.
وتشكل وعي جيلنا -جيل الثمانينيات من القرن الماضي- على سياسات التوزيع من خلال مدرسة اليسار التي كان يقودها جيل من العظام في مصر أمثال إسماعيل صبري عبد الله، وسمير أمين، وفؤاد مرسي، وجودة عبد الخالق (الذي تولى وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011)، بالإضافة إلى مدرسة التبعية -التي أظهرت طبيعة العلاقة بين الجنوب المتخلف أو الذي كان يطلق عليه وقتها النامي وبين الشمال المتقدم- وغيرها على المستوى الدولي.
ما انتهيتُ إليه بعد هذه السنين والتي صرفت فيها أنا شخصيا جهدا كبيرا في تحليل وفهم السياسات الثقافية أو سياسات الهوية؛ أن "ما يحكم السياسة في المنطقة هو المسألة الديمقراطية الممتزجة بسياسات توزيع عادلة للثروة والدخل والفرص، وأن من يصرفها عن ذلك نحو قضايا أخرى -من قبيل سياسات الهوية- هو في نظري آثم".
هذه الفترة أيضا شهدت دمجا واندماجا متصاعدا لحركة الإخوان المسلمين في المجال السياسي منذ دخولهم الانتخابات البرلمانية 1984. انعكس هذا على أولويات الأجندة السياسية من 3 زوايا:
- أولا تصاعد الجدل في قضايا الهوية؛ خاصة أن المقصود من دخول الإسلاميين إلى الساحة السياسية هو الانتقال بالدعوة إلى المجال العام -كما صرح وقتها الأستاذ عمر التلمساني (1904-1986)، المرشد العام للجماعة.
احتدم وقتها وبعدها -ولا يزال- الجدل الإسلامي العلماني ودار حول جميع القضايا من الشأن الفردي إلى هوية الدولة إلى طبيعة الاقتصاد.
- ثانيا رغم غلبة قضايا الهوية على الإخوان، فإنه كانت هناك مزاحمة لها من قضايا أخرى، خاصة قضية الحريات العامة.
انتهيتُ في بحث كان من متطلبات الدكتوراه عام 1993، بتحليل مضمون لمجلة "لواء الإسلام" -التي كانت تعبر عن الإخوان في التسعينيات- إلى أن قضايا الحريات العامة -وليست الفردية- باتساعها احتلت أولوية على قضايا تطبيق الشريعة، وهذا مفهوم، إلا أن الدخول المتزايد للإخوان لساحة العمل العام اصطدم دائما بالقيود التي فرضها نظام مبارك (1981-2011) عليه، ومن ثم فالتوسع فيه يتطلب مزيدا من الحريات العامة.
- ثالثا: لم يستفد الإخوان من الإطار التحليلي الذي قدمته مدرسة اليسار المصرية لفهم السياسات التوزيعية التي بدأها النظام المصري من السبعينيات وتصاعدت في عهد مبارك (1981- 2011) بعد ذلك، والتي قامت على سياسات رأسمالية تناقض العقد الاجتماعي للفترة الناصرية (1954-1970).
وأدرك الإسلاميون الفراغ الذي تتركه الدولة المصرية في انسحابها غير المنظم من توفير الحماية الاجتماعية؛ فملؤوه هم؛ من خلال سياسات تدعم الطبقة الوسطى بتوفير الخدمات والمواد الاستهلاكية، كما جرى في النقابات المهنية، بالإضافة إلى الشرائح الدنيا من المجتمع من خلال العمل الخيري، الذي انتشر في كل مكان من ربوع مصر.
ونحن هنا بإزاء محاولة تخفيف لسياسات التوزيع غير العادلة التي اتبعها النظام، ولسنا بصدد تغيير في هذه السياسات أو معارضة لها.
كانت هذه -دائما- مهمة اليسار الذي انشغل أغلبه بالجدل الثقافي مع الإسلاميين، والذي رأى فيه استعادة لدوره ومحاولة للخروج من حالة الضعف التي أصابته بعد سقوط الاتحاد السوفياتي 1990-1991 لا سيما أننا في هذه الفترة شهدنا انتقال كثير من رموزه للعمل الحقوقي.
وكان لصراعات الهوية التي جلبها الإسلاميون إلى الساحة السياسية آثار كبيرة على تطور اليسار. لقد تحول تركيز السياسيين اليساريين من الدعوة إلى إعادة توزيع عادلة للثروة إلى حماية التعددية الدينية والمواطنة المتساوية من التهديد المتصوَّر للأجندة الإسلامية.
وتتبع هشام سلام -أستاذ العلوم السياسية المتميز بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة- في كتابه الذي حمل عنوان "سياسة بلا طبقات"؛ هذه الإشكالية بالتفصيل في مصر.
ما انتهيتُ إليه بعد هذه السنين والتي صرفت فيها أنا شخصيا جهدا كبيرا في تحليل وفهم السياسات الثقافية أو سياسات الهوية؛ أن "ما يحكم السياسة في المنطقة هو المسألة الديمقراطية الممتزجة بسياسات توزيع عادلة للثروة والدخل والفرص، وأن من يصرفها عن ذلك نحو قضايا أخرى -من قبيل سياسات الهوية- هو في نظري آثم آثم".
وما أحب أن أؤكد عليه بعد هذه السنين الطويلة والتي أعتبرها وصية مرتحل؛ هو "أننا لو صرفنا عشر معشار ما صرفناه في خطابات الهوية في فهم بنى الاستبداد في منطقتنا، وعلاقتها بالاقتصاد السياسي الذي تنتجه لكنا الآن في مكان آخر".
وقد شهدت العقود الأربعة الماضية مقايضة بسيطة بين الهوية والتوزيع، وهي من المقايضات التي باتت تحكم المسرح السياسي العربي الآن من أمثال: الاستقرار في مقابل الاستبداد، وتدخل الدولة وانسحابها، والديمقراطية والنمو الاقتصادي، والهوية الوطنية في مقابل الهويتين العربية والإسلامية، والنمو المستند للرأسمالية والتوزيع العادل.
والسؤال الذي يجب أن نقف أمامه طويلا هو هل يمكن أن نتجاوز تسطيح التفاعل المعقد بين سياستي الهوية والتوزيع في تجارب مختلف الفاعلين السياسيين، مما يقلل التوتر بين الاثنين ويحررنا من المقايضة البسيطة وغيرها من المقايضات التي حكمت -ولا تزال- تفكيرنا السياسي؟
هنا يمكن أن نقدم الملاحظات الأربع التالية :
- أولا: هندسة الأجندات في بيئة استبدادية: وفيها سيتم التلاعب بخطابات الهوية لمصادرة سياسات التوزيع والسياسة الديمقراطية والذي جوهرهما توزيع عادل للثروة والسلطة وانتفاء أية ممارسات احتكارية فيهما.
تشهد كل دول المنطقة تقريبا إعادة صياغة لهويتها الوطنية وموقع الدين فيها أو إعادة تعريف بعض مكوناته من خلال ما يطلق عليه "تجديد الخطاب الديني". وتُستخدم هذه العملية لتحديد هدف النظام وتجديد شرعيته وإقصاء أو ضم بعض الفاعلين السياسيين أو الاجتماعيين. على سبيل المثال صور الرئيس السيسي 2014، وصعوده السلطة في 2013 كمحاولة لحماية "الهوية الحقيقية" لمصر من أولئك الذين يسعون إلى فرض نظام اجتماعي يخالف الطبيعة "الأصيلة" للبلاد.
ويتواكب مع إحياء أو إعادة تعريف الهوية الوطنية سياسات مكافحة الإرهاب والقضاء على حركات الإسلام السياسي لدى بعض الأنظمة، والصراع حول من يمثل "روح الإسلام" في المنطقة، وهو ما يفرض تمدد سياسات الهوية وتوظيف متعمد من الجميع لها في المنافسة والصراع السياسي.
وذلك -كما يرى الدكتور هشام- "لأن الساحة السياسية الوطنية يمكن أن تستوعب في نفس الوقت عددا محدودا من النزاعات، ويُفترض أن زيادة بروز أحد أبعاد الصراع يترافق مع انخفاض في بروز أبعاد أخرى".
ولاحظ العلماء أن الحكام الاستبداديين يمكنهم ممارسة قدر كبير من حرية التصرف في تحديد الانقسامات الاجتماعية التي ستظهر في السياسة الرسمية، وعادة ما يتحكمون في التصميم المؤسسي السياسي ويتمتعون بقدر كبير من الحرية للسماح بمشاركة مجموعة معينة في المنافسة السياسية أو منعها.
- ثانيا: يبدو أن الاقتصاد ذا الطبعة النيوليبرالية المستندة إلى فكرة السوق -الذي حل محل الإله- هو القاطرة التي يجري من خلالها إعادة هيكلة المنطقة وطنيا وإقليميا ودوليا.
وفي القلب من ذلك؛ إعادة تشكيل التوقعات العامة حول دور الدولة في الإنتاج الاقتصادي وتوزيع الموارد، بما يتطلبه من ضرورة التخلص من المسؤوليات المرهقة التي كانت تضطلع بها الدول العربية تجاه مواطنيها.
وينطبق ذلك على الدول النفطية في الخليج التي تعيد صياغة العقد الاجتماعي مع مواطنيها لتتخلص من الدولة الرعوية استعدادا لمرحلة ما بعد النفط، كما ينطبق على الدول غير النفطية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالعقود الاجتماعية التي ورثتها من مرحلة ما بعد الاستقلال.
وقد أصبحت الحاجة الملحة الآن هي تقديم حلول ملهمة ومقنعة للتحدي طويل الأمد المتمثل في القبول بالرأسمالية كمحرك للنمو الاقتصادي مع حماية المجتمع في نفس الوقت من سلبيات الرأسمالية.
بعبارة أخرى؛ إن المهمة الملحة هي معالجة تداعيات فكرة السوق القوية التي يجب ألا تقيدها أي قواعد أو أي تدخل سياسي على الهوية والتوزيع معا.
وإن ما تقدمه الخطابات المعارضة لهذا التوجه في الواقع هو إما دفاع ماضوي عن السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي ربما كانت منطقية منذ عقود ولكنها الآن بعيدة كل البعد عن حقائق الاقتصاد العالمي المتغير، أو نسخة مخففة من الليبرالية الجديدة. وتغيب أية مناقشات جادة لتداعيات فكرة السوق على الهوية.
ونحن ندفع ثمنا باهظا لوهن اليسار العربي وانصرافه المبكر نحو مواجهة الإسلاميين بسياسات ثقافية وإعادة تموضعه في السياسة العربية لمناهضة الإسلاميين سياسيا وثقافيا وتحالف بعض مكوناته مع السلطات القائمة رغم ما بينهما من تناقضات في السياسات الرأسمالية المطبقة.
وخلال العقود الأخيرة من القرن الـ20؛ أخفق اليسار -عربيا وعالميا- في تكريس ما يكفي من الطاقة الفكرية أو التفكير الإستراتيجي للطبيعة المتغيرة للاقتصادات والمجتمعات وما يجب القيام به حيال ذلك. وابتعد اليسار عن التحليلات المفيدة للرأسمالية وركز بدلا من ذلك -كما قدمت- على ما بعد الحداثة، والتعددية الثقافية، والنسوية، وما بعد الاستعمار.
وكان لهذه الاتجاهات القليل من الأهمية أو صدى لدى الناس العاديين، وأثبتت بشكل خاص أنها غير جذابة للطبقة العاملة التي كانت عماد اليسار.
في المقابل؛ كان اليمين النيوليبرالي الذي كان ينظم ويفكر فيما اعتبره عيوب نظام ما بعد الحرب الثانية جاهزا بتفسيرات للمشكلات بالإضافة إلى حلول لها، وامتلك قوة دفع من الدولة والمؤسسات الدولية؛ فكانت فكرة السوق الحرة القادرة أن تفعل كل شيء، وقد ساعده هذا في الحصول على مكانة أيديولوجية عالية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية خلال العقود الأخيرة من القرن الحالي.
السؤال الذي يجب أن يشغلنا هو ما تأثير هذا الصعود المتنامي لصراع الهويات على منطقة تعاني أصلا من انفجار في الهويات ومزيدا من توظيفها في الصراعات السياسية؟
- ثالثا: مدخل القضايا وإعادة تعريف الفعل السياسي:
كتبت سابقا في التحول عن الأيدولوجيات الشاملة كالرأسمالية والاشتراكية والإسلاموية نحو القضايا المحددة مثل الجندر والتغير المناخي وحقوق الإنسان.. إلخ. جرى ذلك من تسعينيات القرن الماضي وتصاعد في الزمن المعاصر.
وحرّفت هذه القضايا الأجندة السياسية عن سياسات التوزيع، رغم أنها جميعها تحوي مكونا منها. على سبيل المثال؛ هناك ربط بين التمييز ضد النساء والفتيات وبين موقعهن في السلم الاجتماعي؛ إذ يقل مساواتهن مع الذكور كلما احتلوا أسفل هذا السلم. كما بات الحديث متصاعدا في الربط بين سياسات البيئة ومكون العدالة فيها، أما خطاب حقوق الإنسان فقد توسع مبكرا ليضم بجوار الحقوق السياسية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
لكن السؤال لماذا لم تفرض هذه القضايا سياسات التوزيع على الأجندة السياسية؟
يمكن أن نقدم 3 أسباب لذلك:
- أدت هذه القضايا إلى تجزئة الواقع على مستوى النظر الفكري أو الفاعلين، ولم تستطع بالانفتاح على بعضها البعض أن تقدم منظورا متكاملا ولا أقول شاملا لسياسات التوزيع. وهذا يتطلب إستراتيجيات أكثر فاعلية لجعل الفاعلين في هذه القضايا مكملين للعمل من خلال الحوار والتسوية.
- كان المدخل لمعالجة هذه القضايا ليس من باب السياسة الحزبية التي يمكن أن تقدم بديلا سياسيا واقتصاديا للحكم القائم، ولكن من مدخل المجتمع المدني، وساهم هذا في مزيد من التجزئة. ونشأت الشبكات داخل كل قطاع، ولم تكن عابرة للقطاعات المختلفة؛ وهذا حال بين الفاعلين وتطوير رؤية مشتركة حول العلاقة بين قضاياهم وسياسات التوزيع.
وأصبحت سياسات القضايا مثل سياسات الهوية في المنطقة؛ إطارا جاهزا يتم من خلاله تحديد الانقسامات. لقد قاموا في النهاية بتفتيت المواطنين أكثر من توحيدهم، مما ساعد على زيادة صعوبة تشكيل التحالفات التقدمية. وكانت الانتفاضات العربية من اللحظات الخاطفة التي جرى فيها خلق مجال مشترك أو ميدان واحد كميدان التحرير من مزيج الهويات المتباينة، ولكنها سرعان ما تبددت لأسباب ليس هناك مجال للتفصيل فيها الآن. - استُخدمت القضايا ليس لتأجيج الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين فقط؛ بل امتد داخل المكون الواحد حين تصاعد الصراع على النفوذ والتمويل بين أنصار كل قضية. ومن الممكن القول إن قضية الجندر -على سبيل المثال- كانت محورية لفهم المواجهة بين العلمانيين والإسلاميين وبين الجماعات النسائية نفسها.
ومن الصعب مع هذه الانقسامات خلق تضامن اجتماعي في بلد يتكون من مجموعة متنوعة من المجموعات ذات التقاليد والثقافات والتواريخ المختلفة؛ فالناس غالبا ما يكونون أكثر استعدادا لمساعدة أولئك الذين يمكنهم التعرف عليهم بسهولة، كما أن التضامن الاجتماعي من مدخل هوياتي فقط يؤدي إلى التكافل والإغاثة وليس تفكيك البنية التي أنتجته، وهذه هي أهمية اليسار.
- رابعا: الانتقال على الصعيد الدولي من صدام الحضارات إلى صراع الهويات:
سبق أن كتبت على موقع الجزيرة نت عن ظاهرة بروز الهويات في السياسة الوطنية والدولية. ويتوقع للعقدين المقبلين تنشيطا للهويات ما دون الوطنية بما يتحدى الانتماء القومي الذي قامت عليه الدولة القومية، بالإضافة إلى بروز الهويات ما فوق الوطنية بحكم العولمة، خاصة بعد تدفق المعلومات.
وينجذب كثير من الناس نحو مجموعات مألوفة ومتشابهة التفكير من أجل المجتمع والأمن، بما في ذلك الهويات العرقية والدينية والثقافية، وكذلك التجمعات حول المصالح.
هذه المجموعات أكثر بروزا، وفي نزاع مستمر، الأمر الذي يخلق تنافرا بين الرؤى والأهداف والمعتقدات المتنافسة. كما يتم إنشاء مزيج من الهويات العابرة للحدود البارزة حديثا، وانبعاث الولاءات الراسخة، وبيئة المعلومات المنعزلة، وتباين خطوط الصدع داخل الدول، وتقويض القومية المدنية، وزيادة التقلبات.
والسؤال الذي يجب أن يشغلنا هو ما تأثير هذا الصعود المتنامي لصراع الهويات على منطقة تعاني أصلا من انفجار في الهويات ومزيد من توظيفها في الصراعات السياسية؟!
إن ظاهرة حرق القرآن والهجوم على مسلمي الهند وسياسات ماكرون ضد المسلمين في فرنسا واليمين الديني في إسرائيل… إلخ، كلها مجرد أمثلة لذلك.
وفي مقابل هذا التصاعد لصراع الهويات، برزت ظاهرة أخرى في منطقتنا أطلقتُ عليها "الانتقال من أيديولوجيا الهوية إلى خطابات المعاش"، ولها ملمحان:
- الأول: أن المطالب المتعلقة بالمعاش الكريم للناس صارت أولوية متقدمة على أيديولوجيا الهوية.
وأنا أدرك أنه جرى ولا يزال استخدام مسائل الهوية للحشد والتعبئة من أطراف عدة، ولكنها كانت سبيلا لزيادة النفوذ السياسي وتحقيق مكاسب انتخابية، أو استخدمت للتغطية على قضايا أخرى، أو لتحقيق التماسك للقاعدة الاجتماعية المساندة.
والطريف أن الاحتجاجات العربية في موجتي الانتفاضات تقدم أمثلة متعددة لتجاوز القاعدتين الاجتماعية والتنظيمية للحركات السياسية لموقف قادتهم، حين سارعوا بالانضمام للحراك، فما كان من قادتهم إلا أن لحقوا بهم بعد أن رفضوا المشاركة فيه أول الأمر، جرى ذلك في لبنان والجزائر والعراق في 2019، كما جرى في مصر واليمن والمغرب في 2011.
- الملمح الثاني: أن ما يتطلع إليه قدر معتبر من الشعوب العربية ليس حديثا في المرجعيات الأيديولوجية والأطر الفكرية العامة، ولكن تقديم سياسات عامة وبرامج تفصيلية من شأنها أن تعالج مشاكل الناس الواقعية وتجيب عن أسئلتهم الصغرى. والسياسة الآن باتت تدور حول معاش الناس، وجوهرها انتقال بالخاص إلى العام، والعام للخاص.
هذه الملاحظات الأربع أردت بها فتح النقاش العام حول إعادة صياغة العلاقة بين سياستي الهوية والتوزيع، مدركا أن المسألة أكثر تعقيدا لتداخلها مع عوامل أخرى كثيرة منها: موقف الأجيال الشابة -وخاصة جيلي "z" و"y" اللذين ولدا في نهاية الألفية السابقة ومطلع هذه الألفية- من حديثنا هذا. ومعرفتنا بأفراد هذه الأجيال قليلة، رغم أنهم يمثلون نسبة معتبرة من السكان تصل إلى الخمس في بعض البلدان العربية.
هذا مثال من أمثلة عديدة للعوامل التي يمكن أن تصوغ العلاقة بين سياستي الهوية والتوزيع.

 سبت, 02 نوفمبر 2024
سبت, 02 نوفمبر 2024 
 سبت, 02 نوفمبر 2024
سبت, 02 نوفمبر 2024 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 
 جمعة, 28 مايو 2021
جمعة, 28 مايو 2021 
 ثلاثاء, 29 أكتوبر 2024
ثلاثاء, 29 أكتوبر 2024 
 خميس, 05 سبتمبر 2024
خميس, 05 سبتمبر 2024 .jpeg)
 اثنين, 12 أغسطس 2024
اثنين, 12 أغسطس 2024 




 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب