-
℃ 11 تركيا
-
2 أبريل 2025
عمرو حمزاوي يكتب: واشنطن: بين زمن هيمنة ولى ومخاوف تتجلى
عمرو حمزاوي يكتب: واشنطن: بين زمن هيمنة ولى ومخاوف تتجلى
-
9 مايو 2023, 3:40:37 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
العمل في مركز للأبحاث السياسية في واشنطن، في حالتي مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، يشعرك اليوم أن العالم يقف على أطراف أنامله في أفضل الأحوال أو أنه يقترب من نهايته الكارثية المحتومة في أسوئها.
ولم يكن ذلك هو حال العاصمة الأمريكية عندما بدأت العمل في مراكزها البحثية في 2005. آنذاك، وعلى الرغم مما كان قد بدأ يتضح بشأن التداعيات الكارثية لغزو أفغانستان والعراق وأكلافها البشرية والاقتصادية والمالية ويرشح عن تورط الولايات المتحدة في انتهاكات مفزعة لحقوق الإنسان في البلدين، كان الأمريكيون لا يشكون، ولو للحظة، في هيمنة بلادهم على العالم كالقوة العظمى الوحيدة وفي تقدم نموذجهم المستند إلى اقتصاد السوق والديمقراطية الليبرالية على كل ما عداه من نماذج إدارة شؤون المجتمعات والدول.
ولما لا، وقد كانت الحرب الباردة قد انتهت في تسعينيات القرن العشرين بانتصار المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وانهيار الاتحاد السوفييتي السابق بعد أن تفككت الكتلة الشرقية وزال حلف وارسو. كان عقد التسعينيات هو عقد الهيمنة الأمريكية الانفرادية على العالم، عقد التدخلات العسكرية من قبل واشنطن وحلفائها الأوروبيين في عديد الصراعات الإقليمية (حرب تحرير الكويت وحروب يوغسلافيا السابقة أمثلة) عقد الاستتباع الروسي للإرادة الغربية الذي جسده الرئيس الأسبق بوريس يلتسين وكمون الصين التي فضلت مواصلة جهودها التنموية في الداخل والابتعاد التام عن التورط في الصراعات المستعرة.
وعندما ضرب الإرهاب الإجرامي في 11 سبتمبر 2001 الولايات المتحدة، تحركت الإمبراطورية الأمريكية لدرء الخطر وفرض الأمن واستعادة الهيبة، فكان غزو أفغانستان ثم غزو العراق ثم حرب عالمية على الإرهاب ثم ضغط لتغيير الحكومات المعادية للإمبراطورية أو على الأقل إجبارها على تغيير سلوكها السياسي الخارجي (ليبيا القذافي نموذجا). وعلى الرغم من أن عوامل التوسع غير المسبوق لساحات التدخل العسكري المباشر للولايات المتحدة والحروب بالوكالة التي خاضها حلفاؤها في كل مكان والأزمات الاقتصادية والمالية العالمية أرهقت القوة العظمى ورتبت حالة من التململ بين الأمريكيين وبعض حلفائهم (خاصة بين صفوف الأوروبيين الغربيين) إلا أن الثقة في تفوق واشنطن وقدرتها على الاضطلاع بأدوار شرطي العالم وجهاز دبلوماسيته الأول ومحفز نموه الاقتصادي وغياب قوى كبيرة تستطيع منافستها لم تكن مجتمعة محل شك.
كان هذا هو المناخ العام المحيط بمراكز الأبحاث السياسية في العاصمة الأمريكية بين 2005 و2010، مناخ لم ترتب به التداعيات الكارثية لغزو أفغانستان والعراق سوى مطالبة بعض فصائل الحزب الديمقراطي بالحد من توظيف الأداة العسكرية في الخارج، ولم تفعل به الأزمات الاقتصادية والمالية (الأزمة المالية 2008 مثالا) غير أن أجبرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة (جورج دبليو بوش وباراك أوباما) على ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات داخليا وخارجيا. بين 2005 و2010، لم يربط أحد، لا في النخب السياسية الأمريكية ولا في مراكز الأبحاث ولا في القطاع الخاص أو الرأي العام، بين النتائج السلبية لسياسات الولايات المتحدة وأزماتها المتصاعدة وبين بدايات محتملة لتراجع الهيمنة الإمبراطورية الأمريكية على العالم ومقدراته.
ثم كان العقد الثاني من الألفية الجديدة، والذي اتسم، من جهة، بعودة تدريجية لروسيا إلى ساحات الفعل الدولي وتوجهها تحت قيادة فلاديمير بوتين لمناوئة الولايات المتحدة في وسط وشرق أوروبا ومناطق مختلفة في الشرق الأوسط (عبر الحليف الإيراني والحليف السوري) وإفريقيا (شمالا وجنوبا) وفي آسيا والمحيط الهادي من خلال التنسيق مع الصين. من جهة ثانية، شهدت الفترة الممتدة من 2010 و2020 صعودا اقتصاديا وماليا محموما للصين التي تحولت إلى صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ووسعت من شبكات علاقاتها الاقتصادية والتجارية والمالية ومن إقراضها التنموي لدول الجنوب ومن استثماراتها في كل مكان، وشرعت في إظهار قوتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في الأقاليم الحيوية لأمنها بمضامينه المتكاملة من منطقة المحيط الهندي-الهادي إلى غرب إفريقيا مرورا بالشرق الأوسط. من جهة ثالثة، حدثت بين 2010 و2020، سلسلة من الانتفاضات الشعبية في بعض بلدان وسط أوروبا والبلقان وفي الشرق الأوسط وفي بعض البلدان الآسيوية والإفريقية ونتج عنها إما تغيير في نظم الحكم أو انهيار مؤسسات الدولة الوطنية وانفجار الصراعات الأهلية أو أزمات أمن إنساني متراكمة وطويلة المدى.
صار واضحا أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الكبرى الوحيدة المتحكمة عالميا في الاقتصاد والتجارة، بل أضحت الصين منافسا شرسا. وباتت لدول الجنوب القدرة على الذهاب إلى الحكومة الصينية وطلب قروضها التنموية
وإزاء كافة هذه الصدمات، خاصة تلك التي ارتبطت بمنطقة الشرق الأوسط بما تحويه من موارد نفط وغاز هائلة ومصالح استراتيجية واقتصادية وتجارية للقوى الكبرى وليس فقط للولايات المتحدة، تحرك كبار العالم لحماية مصالحهم ولم تترك روسيا ولا الصين المجال للمعسكر الغربي المقاد أمريكيا للفعل بمفرده. حضرت روسيا بقوة فيما خص أزمات وصراعات إيران وسوريا وليبيا وبعض البلدان الإفريقية، وحضرت الصين اقتصاديا وتجاريا وتنمويا أولا ثم دبلوماسيا وأمنيا ثانيا في منطقة المحيط الهندي- الهادي ثم في شرق وغرب إفريقيا وفي الشرق الأوسط. ولم يترك الأوروبيون المجال للولايات المتحدة الأمريكية بمفردها لتفرض إرادتها باسم الغرب في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية، بل زاحموها إلى حد ما. وكذلك طور الأوروبيون علاقات تعاون مركبة مع روسيا (استيراد الطاقة مثالا) ومع الصين (الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية الهائلة نموذجا) بينما ابتعدوا تماما عن منافسة واشنطن في منطقة المحيط الهندي-الهادي وفي أمريكا الوسطى والجنوبية.
بين 2010 و2020، إذا، تغيرت التفاعلات العالمية ودخلت على خطوط الصراعات الإقليمية المختلفة وفي سياقات البحث عن المصالح الاستراتيجية عديد القوى الدولية التي غابت لفترات كروسيا أو خرجت من كمونها كالصين أو سعت إلى شيء من الاستقلالية كالأوروبيين. في المقابل، كانت الولايات المتحدة قد استنزفت أدواتها العسكرية والأمنية والكثير من رأسمالها الدبلوماسي والايديولوجي في حروبها الكثيرة بين 1990 و2020، وارتفعت أصوات نخبها السياسية والبحثية تطالب بتقليل «الانكشاف الأمريكي» عالميا، وتحجيم الدور في أوروبا حيث يستطيع الحلفاء الحفاظ على مصالحهم ومصالح واشنطن، والانسحاب من الشرق الأوسط حيث الأزمات والصراعات والحروب الأهلية التي لا تنتهي والمصالح المتراجعة مع الاكتفاء الذاتي الأمريكي من الطاقة، والتركيز على الحد من الصعود الصيني ومن ثم التوجه نحو آسيا خاصة منطقة المحيط الهندي-الهادي والتوجه نحو إفريقيا حيث التبعية للإقراض التنموي الصيني والعلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية مع العملاق الآسيوي في تطور مستمر.
ومع جائحة كوفيد وتداعياتها الصعبة على الاقتصاد العالمي وما نتج عنها من تكالب كبار العالم على تعويض خسائرهم الاقتصادية والتجارية والمالية بأنماط جديدة من استغلال دول الجنوب وبصنوف جديدة من التحالفات الدولية تارة لأغراض التنمية والاستثمار وتارة لأغراض الإقراض، صار واضحا أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الكبرى الوحيدة المتحكمة عالميا في الاقتصاد والتجارة، بل أضحت الصين منافسا شرسا. وباتت لدول الجنوب القدرة على الذهاب إلى الحكومة الصينية وطلب قروضها التنموية ومساعداتها في مجال البنى التحتية والتكنولوجية والصناعية عوضا عن القروض والمساعدات الأمريكية والأوروبية. ثم كان انفجار الحرب الروسية-الأوكرانية التي أظهرت أن روسيا وعلى الرغم من قدراتها العسكرية تحتاج لدعم الصين، وأن أوروبا وعلى الرغم من قدراتها الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية تحتاج للتحالف مع الولايات المتحدة خاصة في مساعيها لكسر التبعية لروسيا في مجال الطاقة.
صار الأمر، إذا، منافسة ثنائية بين الولايات المتحدة، القوة العظمى المتراجعة، وبين الصين، العملاق الآسيوي الصاعد. وهنا غيرت نخب واشنطن السياسية والبحثية مقولاتها عن تحجيم الدور وهنا والانسحاب من هناك، وعادت لماضي المقولات الإمبراطورية عن ضرورة الحفاظ على الهيمنة الأمريكية والحد من صعود الصين بمقارعتها في كل مكان، في المحيط الهندي-الهادي بالتحالف مع الهند ومع اليابان وأستراليا وفي الشرق الأوسط بتجديد علاقات التحالف مع دول كالسعودية والإمارات ومصر وفي إفريقيا بمبادرات تنموية سخية. غير أنها عودة خائفة، تتلمس بها واشنطن ونخبها طرقا غائمة المعالم ومسارات غير مضمونة العواقب بهدف الحفاظ على هيمنة باتت زمانيتها خلفنا وليس أمامنا.

 أربعاء, 02 أبريل 2025
أربعاء, 02 أبريل 2025 
 أربعاء, 02 أبريل 2025
أربعاء, 02 أبريل 2025 
 أربعاء, 02 أبريل 2025
أربعاء, 02 أبريل 2025 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 اثنين, 21 يونيو 2021
اثنين, 21 يونيو 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 خميس, 30 سبتمبر 2021
خميس, 30 سبتمبر 2021 
 اثنين, 01 نوفمبر 2021
اثنين, 01 نوفمبر 2021 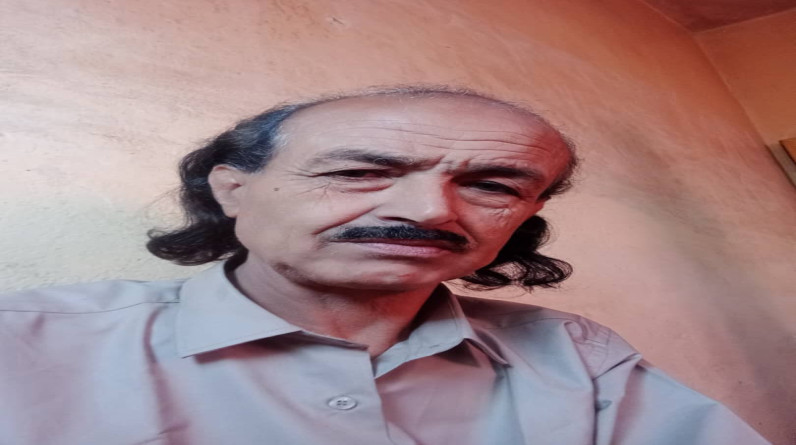
 أربعاء, 02 أبريل 2025
أربعاء, 02 أبريل 2025 
 أربعاء, 02 أبريل 2025
أربعاء, 02 أبريل 2025 




 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب 





